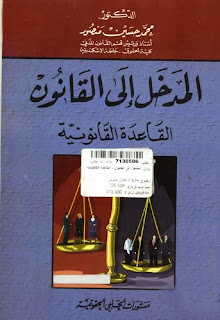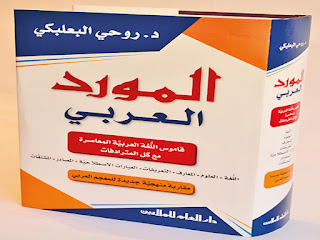من أهم أدوات البحث العلمي: الكتب
المرجعية، كالموسوعات و القواميس..
تعتبر الكتب مرجعية، إذا اضطر الباحث
إلى الرجوع إليها مرارا و تكرار، بمعنى أنه يصعبعليه- إن لم نقل يستحيل- أن يقرأها من أولها إلى آخرها ، و إنما
يراجعها كلما دعت الحاجة.
و هذا الصنف من الكتب، يشمل مجموعة من
المراجع الهامة،من أهمها الموسوعات بكل فئاتها ، و المعاجم الموسوعية، و المعاجم
اللغوية على اختلاف أغراضها..
أولا:الموسوعات:
الموسوع في اللغة العربية هو: " السِفْر أو الكتاب الذي يشمل عموم العلوم،و المؤنث موسوعة".و
إذن فالموسوعة أو دائرة المعرفة أو المعارف( Encyclopedie)، هي "تسجيل، في ترتيب هجائي أو تبويب
موضوعي، للمعرفة التي وصل إليها الإنسان، في شتى الفروع أو في فرع بعينه".
و تختلف الموسوعة عن القاموس من حيث
أنها" لا تقتصر على تقديم التعريف فقط ، بل تقدم تاريخا للموضوع(قد
يكون موجزا) ، و توضيحا لعلله ، و تبيانا لعلاقاته بالموضوعات المشابهة".
و تنقسم الموسوعات إلى عدة
أصناف،فبعضها موسوعات عامة و أخرى موسوعات متخصصة:الأولى تشتمل على معلومات عامة ، عن
كل فروع المعرفة ، و الأخيرة تتضمن معلومات عن فرع أو ميدان خاص من المعرفة.
و من الموسوعات المتخصصة في القانون ،
على سبيل المثال، هناك
موسوعة " شرح القانون المدني المصري" للدكتور
معوض عبد التواب،و "الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية"للأستاذ
محمد عنبر،و "الموسوعة الجنائية" للأستاذ محمد عبد المالك،و موسوعة "داللوز (Dalloz)
للقانون" الفرنسية،و "موسوعة السياسة" تأليف جماعي، تحت إشراف عبد الوهاب
الكيالي، و" موسوعة العلوم السياسية"، تأليف جماعي، من إصدار جامعة الكويت.


و تحظى الموسوعات بأهمية خاصة في
البحث العلمي، إذ يبدأ الباحثون بحوثهم، عادة، بالاطلاع على موسوعة عامة، ثم
موسوعة متخصصة، لأخذ فكرة عامة أو متخصصة ، بسيطة أو معمقة نسبيا عن الموضوع.و تكمن،
أهمية الموسوعات كذلك،لاسيما الكبرى و المتخصصة،في كون موادها أو مقالاتها(articles)،محررة في الغالب من طرف كتاب خبراء
متخصصين في كل فرع من فروع المعرفة. و مما يساعد على استعمال الموسوعات، " أنها تكتب بأسلوب مبسط لا يتطلب فهمه توسط المدرس أو الشروح،
بل يكفي للاستفادة منها الحد الأوسط من الثقافة العامة مع الإلمام بالعلم الموضوعة
له". كما
أنها تتضمن فهارس هجائية، تساعد الباحث على الوصول إلى مراده بسرعة.هذا فضلا على أنها قد تحرص على إصدار ملاحق سنوية، لتحيين المعلومات ،و ملاحقة
المستجدات(كما كانت تفعل الموسوعة البريطانية (Britannica)،قبل توقفها عن
الصدور في شكل ورقي).

هذا، و يتبع معظم المواد أو المقالات،
في الموسوعات " المحترمة"؛ قوائم
بيبلوغرافية مهمة، توجه الباحث إلى أهم
المصادر و المراجع المتخصصة في الموضوع الذي يبحث عنه، يمكنه الرجوع إليها
للاستزادة من المعلومات في هذا الموضوع )و من ضمن هذه المراجع المحال عليها، طبعا، الموسوعات المتخصصة. (كما قد تحيل على مواد أخرى )بنفس الموسوعة(، لها صلة
بالمادة المدروسة، و تعتبر مكملة لها(Les corrélats)
.و
المواد،في أغلب هذه الموسوعات الكبرى ، تحمل توقيعات محرريها.
ثانيا:المعاجم و القواميس:
يعرّف القاموس بأنه:" معجم بالكلمات و معانيها ،مرتبة
أبجديا بلغة واحدة أو بلغة و ما يقابلها في نقلها إلى لغة أخرى".
و تعتبر المعاجم و القواميس، من أهم
أدوات و وسائل الخدمة المرجعية السريعة.
و قد يكون المعجم ثنائي اللغة(bilingue) كالمعاجم
الفرنسية- العربية أو الإنكليزية- العربية، أو الإنكليزية -الفرنسية.كما قد
يكون ثلاثي اللغة(trilingue)(إنجليزي-فرنسي-عربي.. و هكذا.
و هذه القواميس كلها مهمة جدا،
بالنسبة لطلاب العلوم القانونية و
الاجتماعية. غير أنه يستحسن ،في هذا المجال، الحرص
على الاستعانة بالقواميس التي تتوفر فيها بعض مواصفات الجودة التالية:
أ- يستحسن الاستعانة، بالقواميس التي
تزود القارئ بقوائم طويلة من الكلمات المتشابهة في المعنى،حتى يمكنه أن يختار
المعنى الدقيق الذي يبحث عنه؛
ب- يفضل المعاجم التي تستعمل المفردات في
جمل توضيحية، و أمثلة نموذجية. أو التي تحاول استقصاء الكثير من
الأمثلة الدالة على المعاني؛ لأن هناك الكثير من الألفاظ في اللغات الأجنبية التي
يصعب إيجاد مقابل لها في اللغة العربية، و بالتالي لا يمكن للقارئ العربي أن يفهم
المراد منها(و يختار المقابل الصحيح)، أو يعرف كيفية استعمالها، إلا من خلال
الأمثلة باللغة المقابلة؛
ج- و من الأحسن ،أن يحرص الطلاب و
الباحثون على استعمال المعاجم التي تواكب أحدث المصطلحات ، التي تظهر في شتى
المجالات؛
د- هذا، بالإضافة إلى أن الطلاب،لاسيما
طلاب الحقوق، يحتاجون إلى تعلم (نطق) أسماء الأعلام و المصطلحات،..إلخ،
الأجنبية ،كما ينطقها أهلها.فهم لذلك لا يستغنون عن المعاجم التي تورد مع كل كلمة، طريقة لفظها( و غالبا ما
تجد إرشادات النطق في مقدمة المعجم؛
هذا، و لا يفوتني أن أشير في الأخير، إلى نقطة
على جانب كبير من الأهمية، ألا وهي أنه بالإضافة إلى القواميس اللغوية العامة،
هناك أيضا القواميس المتخصصة، ففي العلوم الاجتماعية مثلا نجد "معجم العلوم الاجتماعية" (من إعداد نخبة من العلماء
المصريين و العرب)،و "معجم العلوم السياسية الميسر"للدكتور أحمد سويلم
العمري،و(Dictionnaire Juridique :Français-Arabe) لإبراهيم نجار،و أحمد زكي بدوي،و يوسف شلالا.
و من المعاجم الفرنسية الجديرة بالذكر
هنا، المعاجم الوجيزة(Le lexique)،التي تستعمل في
البحث السريع؛ و من أهمها (Lexique des
termes juridiques)الذي نشر
تحت إشراف (R.Guillien et J.Vincent)،و (Lexique des sciences sociales) تحت إشراف (M.Grawitz).